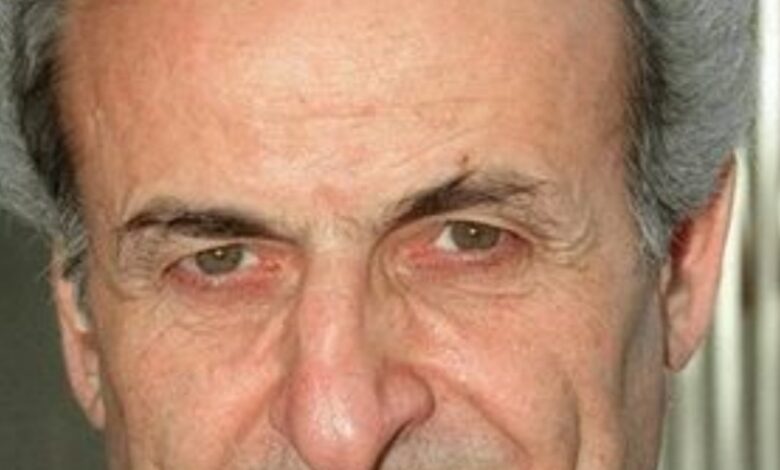
مركزية أم لامركزية اتحادية؟ نظام سلطوي فاسد مطلق أم نظام ديمقراطي وطني ؟ رئاسي أم برلماني ؟
عارف دليلة
مركزية أم لامركزية اتحادية؟ نظام سلطوي فاسد مطلق أم نظام ديمقراطي وطني ؟ رئاسي أم برلماني ؟
نظرة أولية ، من خلال جوابٍ عن سؤالٍ عن ” اعلان سورية الاتحادية ”
إعلان سوريا الاتحادية هو الإعلان الذي صدر بتوقيع عددٍ من الأشخاص المعروفين منهم ابراهيم الجبين وميشيل كيلو وأحمد برقاوي وغيرهم .
هو يشبه ، من حيث الفكرة ، دعوة قسمٍ من السوريين الكُرد في شمال شرق سوريا إلى الإدارة الذاتية الموسّعة ، والتي يشتط البعض منهم ، بعد أن استطاب دفء الغطاء الاحتلالي الأجنبي ،أن يمتدّ به إلى الاستقلال ، متجاهلاً الاعتداء الفجّ الذي سيمثّله ، لو حدث ، على الدولة و الشعب السوري كلْه ، بما فيه السوريين الكُرد أنفسهم ، و متجاهلاً ما يمثّله من اقتطاع لأغنى مساحةٍ من سوريا من أصحابها الشرعيين وتسليمها للمحتلّين الاستعماريين ، في تكرارٍ لما جرى وما زال يتوسّع على أرض فلسطين وما جاورها منذ ثلاثة أرباع القرن !
وظاهر الأمر أنّ هذه الدعوات تأتي كردِّ فعلٍ على النظام (” القاتل لكل اشكال الحياة” كما وصفته في مقابلةٍ مطوّلةٍ نشرت في جريدة الراية القطرية في شهر أيار ٢٠١١ أجراها معي الأخ شادي جابر في شهر نيسان ) ، شديد المركزية وعميق الفساد و متوحّش بالاستئثار و بالإطباق على أنفاس ألشعب السوري أمنياً وممارسة للسلطة المطلقة الغشماء غير المحتكمة إلى دستورٍ أو قانونٍ أو مبادئ أو أخلاقٍ في التصرّف بجميع شؤون ومقدرات وطرائق حياة وتفكير و مصائر الدولة والشعب والمواطنين ، الاقتصادية والسياسية ، العامة والخاصة ، الحاضرة والمستقبلية.
ردُّ الفعل هذا يرى علاج المشكلات الهائلة التي خلّفها هذا النظام أمراً ممكناً بمجرّد تغيير الشكل والأسلوب الإداري من الشكل المركزي جداً إلى الشكل اللامركزي ، والمنفتح على الانفصال وعلى صراعات وتدخّلات احتلالية لا تنتهي ، على أنّ هذا التغيير الشكلي كفيل بتغيير المضمون ، من نظامٍ استبداديٍ فاسدٍ لا وطني متحجّرٍ إلى نظامٍ متقدّمٍ ديمقراطي وطني ! وأنّ هذا التغيير سيحدث عندما يمتلك ويمارس سكان كلّ منطقةٍ أو ولايةٍ أو جماعةٍ بشريةٍ أثنية أو طائفية أو عشائرية .. الخ حقّ تشكيل مستويات السلطة والإدارة المحلية واتّخاذ القرار بأهمّ المسائل الخاصة بهم ، هذا مع بقاء مسائل الدفاع و العلاقات الدبلوماسية الخارجية ، مثلاً ، ( في حال ماقبل الاستقلال !) شؤوناً مركزية تقرّرها السلطة العليا المتشكّلة من ممثّلين لهذه الإدارات المحلية شبه المستقِلّة.
لايوجد نموذج واحد في العالم يُقاس عليه ، بل هناك تدرّجات كثيرة من بلدٍ إلى آخر ، من الدول ذات المركزية الشديدة والسلطة المطلقة للمركز إلى الدول التي تتمتْع فيها السلطات والإداريات المحلية بالقسم الأعظم من الصلاحيات والقرارات . و الأغلب في العالم هو الأنظمة المختلَطة ، وهذه أيضاً مختلٍفة جداً . وهناك أيضاً النظام الرئاسي أو النظام البرلماني تبعاً لحجم الصلاحيات التي يتمتّع بها الحاكم الأعلى أو يتمتّع بها النواب المنتخَبون من قبل الشعب . وهنا تبرز مشكلة حرية الانتخابات ودرجة صدقية التمثيل . وتتدرّج المركزية و اللامركزية ، والنظام الرئاسي أو النظام البرلماني ، ما بين الوجود الرمزي و الاسمي و الشكلي للحاكم الأعلى ، كما في الملكية الدستورية البريطانية التي لا يتدخّل فيها الملك في أيّ شانٍ عام ، وهو يملك ولا يحكم ، كما يُقال ، علماً أنه لايملك إلا اسمياً ، باستثناء ما يخصّ حياته الخاصة وحياة العائلة المالكة ، إذ أنّ مخصّصاته المالية تُحدّد في الميزانية عند إقرارها في البرلمان بقرارٍ من الأغلبية البرلمانية . أمّا جميع شؤون الدولة فهي بيد السلطات الأخرى المستقِلّة ، كالبرلمان و الحكومة والقضاء ، أو اللامركزية الموسّعة كالأقاليم والإدارات المحلية . وأذكر أنّ مخصْصات العائلة الملكية السنوية في بريطانيا كانت ، في التسعينات ، بحدود خمسة ملايين جنيهٍ استرليني ، وزيدت لاحقاً إلى ثمانية ملايينٍ ( وهي أقل بمرات كثيرة ، أو بملايين المرات ، ربّما ، مما يتصرف به بدون حساب مغتصبو السلطات العامة في بلدان متخلّفة متحجْرة ، قد يكون أغلب مواطنيها زاحفبن على بطونهم من شدّة الفقر و التعذيب ) . وتتحدّد مخصْصات الملكة تفصيلاً بالجنيهات وبالبنسات ، وتختلف في كلْ سنةٍ حسب اختلاف المهام والحاجات !
في أواسط التسعينات قضيت في جامعة دورهام في شمال بريطانيا بمهمةٍ علمية من جامعة دمشق ستة اشهر لدراسة اتفاقيات الشراكة التي كان الاتحاد الأوروبي يعرضها على دول جنوب وشرق المتوسط ، ومن بينها سوريا ، وكان قد جرى توقيع عددٍ منها آنذاك ، مثلاً مع المغرب وتونس و الأردن ، وبالطبع ، كان أشملها و أعمقها مع اسرائيل ، الوحيدة التي وقّع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقيةً خاصّةً إضافية عن التعاون العلمي _التكنولوجي ، والتي تجعل اسرائيل مالكةً لكلّ نتائج الأبحاث العلمية _ التكنولوجية التي يتوصّل إليها الاتحاذ الأوروبي بمجرّد مشاركة عالمّ أو باحثٍ اسرائيلي واحد فيها ، ولا تدفع اسرائيل ثمناً لجميع ما تأخذه من نتائج البحوث العلمية سوى مائة مليون دولار سنوياً ، هذا بينما تتلقّى المساعدات من دول الاتحاد بالمليارات !
وحتى وزير خارجية السلطة في سوريا ، الذي محى بعد ذلك أوروبا من الخريطة ، كان قد وقّع مع الاتحاد الأوروبي ، بالأحرف الأولى ، اتفاقية الشراكة ، بعد سنواتٍ طويلة من الأخذ والردّ . وكنا قد عقدنا لمناقشة الاتفاقية بعض ندوات الثلاثاء الاقتصادي ، ثم انقلبت الظروف ، كما نعلم ، ولم يجرٍ التوقيع النهائي على الاتفاقية ، يوم وجدوا أنّ الصداقة الحميمة مع الرئيس التركي أردوغان تُغني عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، على الأقل ، لأنّ السلطة التركية وأي جهةٍ أخرى ، حزبية أو إعلامية ، في تركيا لن تذكر شيئاً بخصوص حقوق الإنسان والمواطن في سوريا ! إذ أنّ العقدة الرئيسة التي كانت ، منذ البداية ، ترهب السلطة في سوريا وتجعلها تصرّ على تعديل بعض البنود في الاتفاقية وتتمنّع طويلاً من توقيعها ، لم تكن الإجحاف الاقتصادي وانعدام التبادل المتكافئ بين سوريا والاتحاد الأوروبي ، وهو ماكنت أشير إليه حينها وكتبته في بحثي الذي لم يحاول الاطّلاع عليه أيّ مُعنيٍّ بهذه الاتفاقبة ، بينما كانوا يستسهلون توقيع الاتفاقيات التجارية التفضيلية لصالح تركيا ، حتى تلك التي كانت تعترض عليها بصورةٍ معلّلة اقتصادياً غرف التجارة والصناعة السورية ، تلك الاتفاقيات التي سارع وزير الخارجية بعد ٢٠١١ ، ومتأخّراً جدّاً ، بعد أن كانت كثير من المصانع في سوريا قد توقّفت عن العمل بسبب الغزو الواسع للمنتجات التركية للسوق السورية ، للاعتراف قائلاً : ” لقد ألغينا ٥٨ اتّفاقاً للتجارة الحرّة مع تركيا بعد أن اكتشغنا أنها كانت جميعاً منحازةً للجانب التركي (!!!) وتتسبْب بعجزٍ كبيرٍ في الميزان التجاري السوري !
وفي الحقيقة ، كان المانع لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليس مثل هذه العلاقات التجارية المجحِفة بالاقتصاد السوري ، إنما فقط تلك البنود التي تتضمّن الإشارة ، وإنْ كان على استحياءٍ وبكلماتٍ شديدة الدبلوماسية ، إلى ضرورة مراعاة السلطة لبعض حقوق الإنسان والقضاء العادل وحرية الرأي للمواطنين السوريين ، وهي الأمور التي لا يقبل النظام أيّ كلمةٍ من خارج الحدود حولها لأنه يعتبر نفسه دولةً مستقلّةً ذات سيادةٍ وعزةٍ وكرامةّ قوميةٍ لا تتحمّل أيّ تدخّلٍ في الشؤون الداخلية قد يصل إلى حدّ الانتقاص من السيادة . وهي كلمة حقٍّ يُراد بها باطل !
فكأنّ هذه الأوصاف لا تتأثّر بما تفعله السلطة الحاكمة نفسها بشؤون وإدارة بلدها وكيف تتصرّف بمقدرات شعبها ومصائر مواطنيها ( وقد تحدّث العديد من الوطنيين السوريين الشرفاء من أصحاب العقل والضمير ، بجرأةٍ بالغةٍ ، عن جميع هذه الأوضاع عندما أُتيحت الفرصة ، ليومين فقط وفي اجتماعّ مغلقٍ ضمن جدران مدرّج جامعة دمشق ، بين لجنةٍ مشكّلةٍ من ستةٍ من ” أمناء ” مايُسمّى ب “أحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية ” ( ممّن دخلوا التاريخ السوري بصفتهم من كبار الغاسدين !) وبين الصحفيين والكتّاب و أساتذة الجامعة ، وبعد تقديمٍ مسهب شديد التواضع مفعم بالاعتراف الصريح بالخطيئة ، وللمرة الأولى و الأخيرة من قٍبل القيادة ( اللامسؤولة عن أيّ شيءٍ !) ، وبعد وعودٍ وأيمانٍ معظّمة من قِبل هذه ” القيادة” بانّ الأوامر العليا قد اتْخُذت بتعميم هذه الاجتماعات الحرّة المفتوحة على جميع نواحي القطر وجميع المنظمات الشعبية مع ضماناتٍ مؤكّدةٍ بتوفير شروط ممارسة الحرية الكاملة في الانتقاد ضدّ أيّ عسفّ من اعتقالٍ أو تضييقٍ أو خطرٍ . ويومها تحدّث الكثيرون ، ومن بينهم كاتب هذه الأسطر ، بأحاديث يمكن اعتبارها تقدمة لما عرفته أنشطة وندوات ربيع دمشق عامي ٢٠٠١_٢٠٠٢ ، والتي كانت كافية ، في المناسبتين ، لو كان هناك عقل وضمير يستوعبها ، لانتشال سوريا من حضيض الحضيض الذي كانت تتمرّغ فيه إلى مصاف واحدةٍ من الدول التي يُضرب بها المثل بالرفعة والتقدّم وحرية وكرامة مواطنيها . لكنّ ماحدث في المناسبتين كان الانقضاض الفوري والعاجل و بأكثر الوسائل إرهاباً على كلّ مٌنْ”استغلّ” المناسبتين وقال كلمة الحق والشرف و الوطنية ، ” منتهزاً !!!” الفرصة التي أتاحتها الدعوة التوريطية لممارسة النقد والوعود الفاقعة التي جرت على لسان كبار رجال السلطة تشجيعاً لأصحاب الرأي والضمير على ممارسة حرية القول ، لسويعات ٍأو لأيامٍ قليلة ، ليقع الغدر بكلّ مٌنْ تصرّف وفقاً للوعود الغادرة العليا ! ) .
إنّ السوريين الشرفاء من أصحاب العقل والضمير الذين كانوا يطمعون بمستقبلٍ مشرّفٍ لوطنهم وأبنائهم فعوقبوا يأشدّ العقاب ، هم الذين”كانوا وراء” حرص السلطة على تفنيد كلّ كلمةٍ وحرفٍ في اتفاقية الشراكة التي كانت ستوقّع بينها وبين الاتحاد الأوروبي ، وذلك للحيلولة دون أن ” يستغلّ ” أيّ طرفّ خارجي أي بندٍ أو كلمةٍ في الاتفاق تسمح له بنصرة أو الدفاع عن أيّ مواطنٍ يمكن أن يتعرْض لأيّ نوعٍ من أنواع الاضطهاد في البلدان التي أبرمت تحميل الاتفاقية بسببٍ من ممارسته حقّه الطبيعي والدستوري في إبداء الراي . وكانت دول الاتحاد الأوروبي تهدف ، أكثر ما تهدف ، من اتفاقيات الشراكة الحدّ من موجات الهجرة من دول جنوب وشرق المتوسط المتخلّفة إليها ، وكأنها كانت تستشعر وتستبق ماحدث في السنوات الأخيرة . ألم تجرٍ ، حتى في تلك السنوات ، وفي ظروفٍ “سلمية ” هجرة ثلاثة ملايين من السوريين إلى الخارج ، وبالأخصّ إلى الغرب ؟
لقد كانت السلطة دائماً واعية وحريصة ” على أن لا تترك ثغرة في علاقاتها الخارجية يتسلّل منها النقد لأوضاعها الداخلية و لمسؤوليها المتحلّلين من أيّ مسؤوليةٍ عن أيْ شيءّ تجاه الشعب ، المولعين فقط بتضخيم حصائل نهبهم للدولة والشعب وتهريب سرقاتهم الهائلة إلى حساباتهم المنتشرة في أصقاع الكرة الأرضية ، حتى ولو أدّت تصرْفات هذه الحفنة من الأشخاص إلى إزالة الدولة والشعب من الوجود ، سواءً بدون أيْ حربّ ،أو بحربٍ لا تبقي ولا تذر !
لكن ، وكما يقول المثل العربي ” من مأمنه يؤتى الحذر ” فإنّ السوريين والعالم يرون هذه الأيام المحاكم الآوروبية وهي تحاكم بعض رجال السلطة السورية ، المسؤولين عن مشاركة وحماية أرباب الفساد بالممارسات القمعية لشعبهم ، والذين يقعون بين أيديها نتيجة سوء تقديرٍ منهم ، ودون أن يؤثّر ذلك على استمرار النظام في غيّه واستبداده ، وكأنه لم يفعل شيئاً ، بعد ، رغم أنه لم يبق على الأرض السورية شيء اسمه الدولة والشعب و الإنسان والاقتصاد و الدستور والقانون والحقوق العامة و الخاصة ، واولها حقّ الحياة والحقّ بالأرض والمأوى وبما يقيم الأود ، أسوةً ب ” حقوق الحيوان” !
كان من الطبيعي أن يستفيد من هذه الظروف التي خلقتها الممارسات السوداء للنظام المستبد الفاسد العديد من الأطراف في الداخل السوري ، سواءً بالحقّ أو بالباطل . في عرض تجاربهم أو أفكارهم . لكنّ البحث عن المخرَج من الكارثة العظمى وعن العلاج لها لا يكون بالبدء من ظاهر الأمور ، وإنما من جوهرها !
وبالطبع ، فإننا نشير هنا إلى تجربة البعض من المواطنين السوريين الكُرد ، و كذلك إلى نظرية الموقّعين على “إعلان سوريا الاتحادية ” ، الاولون بالممارسة على أرض الواقع باقتطاع جزءٍ غالٍ من سوريا واستغلال ونهب مقدراته العظيمة التي هي ملك للشعب السوري المحروم ، وليست ملكاً لأيّ سلطة أمر واقع محلية طارئة ظهرت في ظرفٍ شاذٍ ، وتقييد حريات سكّانه بما لايختلف جوهرياً عن تصريف النظام لهذه المقدرات والشؤون ، على مدى عقودٍ ، بما في ذلك تسليمها أخيراً للاحتلالات الاجنبية المعادية . أما الآخرون في إعلانهم فيساهمون في تسويق فكرة الادارة الذاتية والدولة الاتحادية والترويج لها ، أيضاً لتكون شكلاً معمّماً لنظام الحكم والإدارة في سوريا ، والاثنان لا يربطان مشروعيهما بحلّ المسألة الأساسية ، اولاً ، بتوافق قوى الشعب السوري حول التغيير الوطني والانتقال السياسي إلى نظامّ جديدٍ يحظى بثقة عموم الشعب السوري وموافقة الأغلبية العظمى منه !
ووجهة نظري في المسألة تتلخّص بأنه ، في القضايا المصيرية والاستراتيجية ، يجب ، أولاً ، لا يصحّ التسرّع والتسابق لإملاء ما يشاء البعض ويخدم مصالحهم الخاصة غير المبرّرة ، منطقياً ، وغير الشرعية ، سياسياً وقانونياً ، والمدمّرة للجميع ، اقتصادياً و استراتيجباً، على عموم الشعب السوري أو محاولة فرضه عليه كأمرٍ واقعٍ ، وحتى لو تطلّب الأمر أن يحقّق ذلك بالعنف و بالغصب ، بل ، والأنكى من ذلك ، بالإسناد والدعم الخارجي المدجّج بالمال الحرام و بأحدث وأقوى التقنبات العسكربة من قٍبل محتلّين مجرّبين كثيراً فاسدي النية والطوية ، ممّن كان آباء الجيل الحالي من المناضلين الوطنين الشرفاء لم يبخلوا بشيءّ لكي يطردوهم من الأراضي السورية ويسلّموها بكلّ إباءٍ وشموخٍ ،نظيفةً طاهرةً ، لأبنائهم من هذا الجيل ، دون آن بخطر في بالهم أن تقوم حفنة من مسوخ هذا الجيل المشوّهين أخلاقياً ووطنياً بنهبها و إفقار و إذلال أهلها الميامين ومن ثم الاستقواء عليهم بالمستعمرين السابقين أنفسهم أو بمَن يزيدونهم سوءاً ، وباستدعائهم لتقاسم سوريا لاحتلالها من جديد ، بعد تدميرها وجعلها غير قابلة للحياة عشر سنواتٍ ، على الأقل ، كما يصف ابن خلدون دمشق قبل أكثر من ستمائة عامٍ بعد أن تركها تيمورلنك هباباً يباباً ، مع تعميم تجربة تيمورلنك المشؤومة على كامل سوريا الحالية ! وهو ما جرى و يجري هذه الأيام في تكرارٍ مُهلكٍ ومنفرٍ لما تعتاد على ارتكابه الأنظمة الاستبدادية الفاسدة !
وأخيراً ، يجب أن نقول كلمةً لحسَني النيّة من بين دُعاةِ هكذا ” وصفات إنقاذية !” : يجب الحذر من تغليب الشكل على المضمون !
يجب العمل ، بدايةً ، بما يُرضي الشعب والرأي الوطني السوري العام ، ثم يجب إعطاء الأولوية للمضمون ، لأن الأمر الجوهري هو طبيعة السلطة والنظام الذي يحكم الوطن ويُدير مقدراته ، على أيّ مساحةّ جغرافيةٍ أو مجموعةٍ بشريةٍ قام :فاسد أم غير فاسد ، ديكتاتوري أم ديمقراطي ! فاذا كان النظام القائم على كامل الدولة فاسداً ومستبدّاً ، فبالأحرى ، فإنه سيكون كذلك في كلّ إقليم أو ولاية أو طائفة أو عشيرة أو إدارة أو مؤسسة أو حتى عائلة ، بغضْ النظر عن الحجم أو درجة المركزية أو اللامركزية ، والعكس بالعكس . والنظام البرلماني واللامركزي في العراق اليوم أبلغ مثالٍ على ذلك . هذا بينما كلّ العالم اليوم يتحدّث عن تفوّق النظام المركزي الصيني على جميع الليبراليات والديمقراطيات الغربية في نجاحه المبهر والسربع في مواجهة واحدٍ من أكبر الأخطار في التاريخ البشري ، وهو جائحة فيروس كورونا ، مع استثناء عددٍ من الديمقراطيات الغربية التي كانت بالأصل وقبل الجائحة أكثر من يُعلي مكانة الإنسان والمواطن بالرغم من الاعترأف بقوانين السوق الاحتكارية الوحشية الراسمالبة ومعبودها الأعلى : المال والربح ، كالدول الاسكندينافية وألمانيا والنمسا واليونان …
والحديث يطول !







