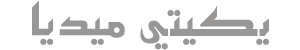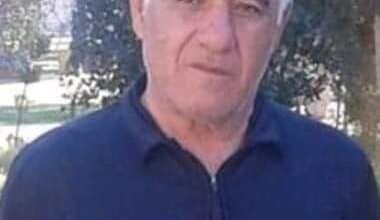الحضارة الكُردية
الكاتب والروائي المصري
خالد حســــــين
♣︎♣︎المقدمة البحثية
تُشكِّل الحضارة الكردية حالةً استثنائيةً في دراسات الشرق الأوسط، ليس فقط لغياب الكيان السياسي الموحِّد الذي يجسِّدها، بل أيضًا لتعقيداتها التاريخية والثقافية التي تختزل تناقضات المنطقة بأسرها. فالكرد، الذين يُقدَّر عددهم بنحو ٣٠-٤٠ مليون نسمة، يُمثِّلون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، وأكبرها بدون دولة قومية، وهو واقعٌ جيوسياسيٌ نتج عن تقاطعات الاستعمار وتفكيك الإمبراطوريات (العثمانية والفارسية) وتدخلات القوى الدولية الحديثة. ومع ذلك، فإن استمرارية الهوية الكردية، رغم التشظي الجغرافي والسياسي، تُقدِّم نموذجًا ثريًّا لدراسة مفاهيم مثل “القومية دون دولة” و”المقاومة الثقافية” في سياق الهيمنة المركزية للدول التي تتقاسم أراضي كردستان التاريخية (تركيا، إيران، العراق، سوريا).
من هنا، تنبثق الإشكالية المحورية لهذا البحث: كيف نجح الكرد في الحفاظ على تماسك هويتهم الثقافية والسياسية عبر القرون، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي هددت وجودهم ككيان متميز؟ للإجابة على هذا السؤال، يعتمد البحث منهجيةً متعددة التخصصات تجمع بين التحليل التاريخي النقدي (إعادة قراءة المصادر القديمة والحديثة بشكٍّ منهجي)، والأنثروبولوجيا الثقافية (دراسة العادات، الدين، البنى الاجتماعية)، واللسانيات (تحليل تطور اللغة الكردية ولهجاتها)، مع إيلاء اهتمام خاص للسياقات السياسية المعاصرة وتأثيرها على تشكيل الرواية الكردية.
لا يخلو هذا الموضوع من التحديات، لعل أبرزها السياسة المُعَولَمة للذاكرة، حيث تُعيد الدول الحاكمة (كالدولة التركية) كتابة التاريخ لتهميش الدور الكردي، بينما تُنتج الحركات القومية الكردية سردياتٍ مضادةً تبالغ أحيانًا في تصوير الوحدة التاريخية للكرد. لذا، يتحرى البحث النزاهة عبر تفكيك هذه الروايات المتضاربة، والاعتماد على مصادر أولية مثل وثائق الأرشيف العثماني، وتسجيلات الرحالة الأوروبيين (ككارستن نيبور في القرن الثامن عشر)، وأدبيات الكرد أنفسهم (كملحمة “مم وزين” للشاعر أحمدي خاني في القرن السابع عشر)، فضلًا عن الدراسات الحديثة التي تستند إلى علم الآثار وعلم الجينات.
يأتي هذا البحث أيضًا في سياقٍ أكاديميٍ تشهد فيه الدراسات الكردية تطورًا ملحوظًا بعد أحداث القرن الحادي والعشرين، مثل صعود نفوذ إقليم كردستان العراق، ودور الفصائل الكردية في الحرب ضد تنظيم داعش، وتصاعد المطالب الانفصالية. إلا أن التركيز هنا ينصب على الجذور العميقة لهذه التحولات، بدءًا من العصور القديمة (حيث تُلمح النقوش الآشورية إلى قبائل “الگوتي” التي قد تكون من أسلاف الكرد)، مرورًا بالعصر الإسلامي الذهبي (حين أسس الأيوبيون الكرد، بقيادة صلاح الدين، إمبراطوريةً امتدت من مصر إلى العراق)، وصولًا إلى الحقبة الاستعمارية التي رسمت حدود كردستان الحالية عبر اتفاقية سايكس-بيكو (١٩١٦).
أخيرًا، يهدف البحث إلى تجاوز النظرة التبسيطية التي تُصور الكرد كضحايا دائمين أو كمتمردين فوضويين، عبر كشف الديناميكيات الداخلية لمجتمعهم: تنافس الزعامات القبلية، تأثير التصوف الإسلامي، تفاعل الأقليات الدينية (كالإيزيديين)، وأدوار النخب المثقفة في تشكيل الهوية الحديثة. كما يتطرق إلى إشكالية “الهُجنة الثقافية” التي يعيشها الكرد، بين الانتماء إلى عالمهم المحلي والانفتاح على العولمة، وبين الحفاظ على التقاليد وتبني قيم الحداثة.
باختصار، هذه الدراسة ليست مجرد سردٍ لتاريخ شعبٍ مهمَّش، بل محاولةٌ لفكِّ تشابك العلاقة بين الهوية والجغرافيا، بين الذاكرة الجماعية والصراع على السلطة، في واحدة من أكثر مناطق العالم تأزُّمًا.
♣︎♣︎ الفصل الأول:
الأصول التاريخية – بين الأسطورة والتأريخ والصراع على الهوية.
تشكِّل دراسة الأصول التاريخية للكرد تحديًا منهجيًّا وعلميًّا، لا ينفصل عن الصراعات السياسية المعاصرة حول الهوية في الشرق الأوسط. فالتاريخ الكردي، بوصفه تاريخًا “مغيبًا” أو “مُعاد تشكيله” من قبل دول المنطقة، يفرض على الباحث مهمة تفكيك طبقات متداخلة من الروايات: السرديات القومية الكردية التي تسعى لبناء سرد متصل منذ العصور القديمة، والروايات الرسمية للدول الحاكمة (تركيا، إيران، العراق، سوريا) التي تتعامل مع الوجود الكردي كظاهرة طارئة أو تمرد قبلي، إلى جانب كتابات المستشرقين والرحالة الأوروبيين التي تتأرجح بين الانبهار بالكرد كـ”كثوار أحرار” وتصويرهم كمجموعات بدوية غير متحضرة.
١. الجذور القديمة: من الكاردوخ إلى الميديين
تعود أقدم الإشارات إلى مجموعات سكانية في مناطق كردستان الحالية إلى النقوش الآشورية (الألفية الأولى قبل الميلاد)، التي ذكرت قبائل مثل “الگوتي” و”لولوبي” في جبال زاغروس، والتي يُعتقد أن بعضها اندمج لاحقًا في النسيج الكردي. إلا أن الإشارة الأكثر إثارة للجدل جاءت في كتابات زينوفون (القرن الرابع ق.م)، الذي وصف في كتابه “الأناباسيس” شعب “كاردوخي” مقاومة شرسة ضد جيشه المتراجع، رغم أن علماء مثل ديڤيد ماكدوال يحذرون من الخلط بين التسمية الجغرافية (“كاردوخ”) والهوية العرقية الحديثة.
من ناحية أخرى، تعتمد بعض التيارات القومية الكردية على فرضية تربطهم بالميديين، الإمبراطورية الإيرانية التي حكمت في القرن السابع ق.م، مستندةً إلى تشابه لغوي بين الكردية واللغة الميدية. لكن التحليل اللسني الحديث، كما يوضح گارنيك أساطريان، يشير إلى أن الكردية تنتمي إلى الفرع الشمالي الغربي للغات الإيرانية، بينما الميدية تنتمي إلى الفرع الجنوبي الشرقي، مما يُضعف فكرة الاستمرارية المباشرة. مع ذلك، يرى باحثون مثل ڤلاديمير مينورسكي أن التمازج بين الميديين والقبائل المحلية في زاغروس قد شكَّل نواة الهوية الكردية المبكرة.
٢. العصور الوسطى: الإسلام والإمارات الكردية
مع الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، دخل الكرد في تفاعل مع الحضارة العربية الإسلامية، لكنهم حافظوا على استقلاليتهم النسبية عبر إمارات محلية، مثل الحسنويين (٩٥٩–١٠١٥ م) في إيران الحالية، والدوستكية في شمال العراق. إلا أن الحدث الأبرز كان صعود الدولة الأيوبية (١١٧١–١٢٦٠ م) تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي، الكردي الأصل، الذي وحَّد مصر والشام وحارب الصليبيين. يثير هذا الدور تناقضًا في الرواية التاريخية: ففي الوقت الذي يُحتفى بصلاح الدين كبطل إسلامي، تُهمش هويته الكردية في الخطاب الرسمي العربي،.
في العهد العثماني-الصفوي (القرن ١٦–١٨)، حصلت إمارات كردية على حكم ذاتي واسع عبر نظام “الإمارات التابعة” (مثل إمارة بهدينان وسوران)، وفقًا لاتفاقية أماسيا (١٥٥٥) وزهاب (١٦٣٩) التي قسمت كردستان بين الإمبراطوريتين. لكن سياسة “التحديث” العثمانية في القرن التاسع عشر (التنظيمات) قضت على هذا النظام، مما أشعل ثورات كردية مثل ثورة بدرخان بك (١٨٤٧).
٣. العصر الحديث: من سايكس-بيكو إلى جمهورية مهاباد
بعد الحرب العالمية الأولى، مثَّلت معاهدة سيفر (١٩٢٠) لحظة أمل كردية بتأسيس دولة مستقلة، لكن إلغاءها لصالح معاهدة لوزان (١٩٢٣) قسَّم كردستان بين أربع دول. في هذا السياق، برزت حركات تمرد مثل ثورة الشيخ سعيد بيران (١٩٢٥) في تركيا، وجمهورية أرارات (١٩٢٧–١٩٣٠)، وجمهورية مهاباد (١٩٤٦) في إيران، التي تُعتبر أول كيان كردي حديث، رغم عمرها القصير (١١ شهرًا).
هذه المرحلة تكشف تحولًا جوهريًّا: من “المقاومة القبلية” إلى “القومية الحديثة”، بتأثير مثقفين مثل محمد أمين زكي، الذي صاغ في كتابه “خلاصة تاريخ الكرد وكردستان” (١٩٣١) روايةً وطنيةً تجمع بين التاريخ واللغة كأساس للهوية.
٤. إشكالية التأريخ: بين المصادر الخارجية والذاكرة الشفوية
يواجه الباحث معضلة الاعتماد على مصادر غير كردية (عربية، فارسية، تركية، غربية) لتأريخ الشعب الكردي، فالمصادر الكردية المكتوبة قبل القرن التاسع عشر نادرة، بسبب هيمنة الثقافة الشفوية. حتى المصنَّف الكردي الأشهر، “شرفنامه” (١٥٩٧) لشرف خان البدليسي، كُتب بالفارسية! كما أن النظرة الاستشراقية، مثل كتابات باسيل نيكيتين، رغم أهميتها، تنطلق من منظور خارجي يختزل الكرد في “البداوة” و”التمرد”.
في المقابل، تعتمد السردية القومية الكردية على ملاحم شعرية مثل “مم وزين” (١٦٩٢) لأحمدي خاني، التي تُصور الشعب الكردي ككيان ضائع السيادة، لكنها تتعرض لانتقادات بسبب إسقاط المفاهيم القومية الحديثة على نصوص تاريخية.
♧♧ خاتمة الفصل: التاريخ كساحة صراع.
لا يمكن فصل الجدل حول الأصول التاريخية للكرد عن الصراع المعاصر على الأرض والهوية. فالتاريخ هنا ليس مجرد ماضٍ، بل أداة لتأكيد الشرعية أو تفكيكها. ومع ذلك، تشير دراسات علم الوراثة الحديثة، مثل بحث لوكا كافالي-سبفورزا
“عالم وراثة إيطاليً” (٢٠٠٤)، إلى تميُّز المجموعات الكردية بخصائص جينية تعكس عزلتهم الجبلية وتفاعلهم مع الشعوب المجاورة، مما يعزز فكرة الهوية المركبة التي ترفض الثنائيات البسيطة (أصل “نقي” vs. “هجين”).
بهذا، يصبح الفصل الأول مدخلًا لفهم الديناميات الأعمق للقضية الكردية: صراع بين الذاكرة والنسيان، بين المركز والهامش، وبين الرواية الواحدة وتعددية الأصوات.
♣︎♣︎ الفصل الثاني:
الهوية الثقافية – التعددية كحصنٍ ضد الاندثار.
تُشكِّل الهوية الثقافية الكردية نسيجًا معقدًا من التقاليد واللغات والعقائد التي صمدت أمام محاولات التذويب القسري، لتصبح أداةً للمقاومة الوجودية. هذه الهوية، التي تُبنى على ثنائية “التمرُّد” و”التكيف”، لا تنفصل عن الجغرافيا الجبلية الوعرة لكردستان، التي عزَّزت العزلة النسبية للكرد، لكنها أيضًا جعلتهم جسرًا بين الحضارات. في هذا الفصل، نُفكِّك مكونات الهوية عبر ثلاثة محاور: اللغة كوعاءٍ للذاكرة الجماعية، والدين كساحة صراعٍ بين الوحدة والانقسام، والفنون كتعبيرٍ عن الوجود السياسي.
١. اللغة الكردية: من التهميش إلى الثورة اللغوية
اللغة الكردية، بلهجاتها الرئيسية (الكُرمانجية، السورانية، البهدينانية، الزازاكية)، تنتمي إلى الفرع الشمالي الغربي للغات الإيرانية، وتُعتبر العمود الفقري للهوية الكردية. رغم ذلك، ظلَّت لقرونٍ لغةً شفويةً بفعل سياسات منع التعليم الرسمي، كما في تركيا (حيث حُظرت حتى عام 1991)، أو تهميشها في العراق وإيران لصالح العربية والفارسية.
♧ الصراع على الحروف: يعكس اختيار الأبجدية (لاتينية في تركيا وسوريا، عربية في العراق وإيران) انقسامًا سياسيًّا. ففي ثلاثينيات القرن العشرين، قاد جلادت بدرخان حركةَ تبني الأبجدية اللاتينية للكُرمانجية، بينما اختارت السورانية الأبجدية العربية لتقريبها من الإسلام.
الثورة اللغوية المعاصرة: بعد حظر دام عقودًا، شهدت الكردية نهضةً في القرن الحادي والعشرين، عبر إنشاء قنوات تلفزيونية (كRudaw وMed TV)، وإدخالها في التعليم الرسمي بإقليم كردستان العراق، بل وصياغة مصطلحات علمية حديثة، كما في معجم ئه ده بي کوردی (الأدب الكردي) لعبد الله گوران.
التحديات: لا تزال اللهجات الكردية تواجه خطر التشرذم، خاصةً مع صعود الزازاكية (التي يُجادل بعض اللسانيين بأنها لغةٌ مستقلة)،
٢. الدين والعقائد: الإسلام والهرطقات المُقاوِمة.
على عكس الصورة النمطية، لم يكن الكرد مجرد “مسلمين سنة”، بل شكَّلوا خليطًا دينيًّا فريدًا يعكس تنوع كردستان:
الإسلام الصوفي: سيطرت الطرق الصوفية (القادرية، النقشبندية) على المشهد الديني، حيث تحوَّل شيوخ الطرق، مثل الشيخ محمود البرزنجي (ثورة 1919 ضد البريطانيين في العراق)، إلى قادة سياسيين.
الأقليات الدينية:
الإيزيديون: الذين يُعتقد أن ديانتهم المانوية-الزرادشتية تُمثِّل أقدم العقائد الكردية، تعرَّضوا لاضطهادٍ متكررٍ (أبرزه مجزرة سنجار 2014 بداعش)، مما دفعهم إلى إعادة تعريف أنفسهم كـ”كرد” رغم محاولات تصويرهم كطائفة منفصلة.
العلويون: في تركيا وسوريا، تُمثِّل المعتقدات العلوية (المُتأثرة بالغنوصية) هويةً كرديةً مضاعفة، تُواجه تمييزًا مزدوجًا: ككرد وكعلويين.
التحولات الحديثة: مع صعود العلمانية في الحركات الكردية (كحزب العمال الكردستاني PKK)، برزت نزعاتٌ لـ”علمنة الهوية”، لكنها اصطدمت بالتديُّن الشعبي، كما في احتجاجات ديار بكر 2021 ضد حظر الحجاب في مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية بسوريا.
٣. الأدب والفنون: الجمالية كفعل مقاومة.
لم تكن الإبداعات الكردية مجرد تعبيرٍ عن الذات، بل سلاحًا للحفاظ على الوجود:
الملاحم الشعرية: مثل “مم وزين” (1692) لأحمدي خاني، التي حوَّلت قصة حبٍ تراجيدية إلى رمزٍ للتحرر القومي (“لو كان للكرد دولة، لَصِرتُ بطليموس عصرهم”، كما كتب خاني).
الأدب النسوي: برزت أصواتٌ مثل سيداي توران في رواية “المرأة التي تخطو على الألغام” (2016)، التي تنتقد البطريركية داخل المجتمع الكردي نفسه.
الموسيقى: من أغاني الشعبية (الدلوك) إلى موسيقى الدنگبێژ الثورية، استخدم الكرد الفن لنقل رسائل التمرد. وأناشيد وحدةٍ للمتظاهرين في إيران وتركيا.
السينما: مثل فيلم “ذيب” (2016) للمخرج الكردي نوري بيلجى سيلان، الذي رُشح للأوسكار، وقدم صورةً إنسانيةً عن مقاومة الكرد دون خطابية سياسية مباشرة.
٤. التحديات المعاصرة: العولمة والهُوية الهجينة
في عصر العولمة، تواجه الهوية الكردية إشكالية “الانزياح الثقافي”:
الهجرة والشتات: أدت هجرة ملايين الكرد إلى أوروبا (خاصة ألمانيا) إلى ظهور جيلٍ يعيد تعريف “الكردية” عبر الفضاء الرقمي وليس الجغرافيا، كما في منصات مثل “Kurdipedia”.
الاستلاب الثقافي: يحذِّر العديد من الباحثين من تحويل التراث الكردي إلى “فولكلور سياحي” في إقليم كردستان العراق، حيث تُختزل الثقافة في الرقصات والأزياء التقليدية، بينما تُهمش المضامين السياسية العميقة.
♧♧ خاتمة الفصل: الثقافة كحقل ألغام سياسي
الهوية الثقافية الكردية ليست كيانًا ثابتًا، بل ساحة صراعٍ دائمة: بين المحلي والعالمي، بين الإسلام والعلمانية، بين الذاكرة والنسيان. لكن هذا الصراع نفسه هو ما يحول الثقافة من مجرد تراثٍ إلى مشروعٍ حيويٍّ للبقاء. فكما كتب الشاعر جكرخوين:
“لو أُخذت منّا الأرض، فسنحمل الوطن في قصائدنا”.
هذا الفصل يؤكد أن الثقافة الكردية، رغم هشاشتها الظاهرة، هي أقوى أسلحة شعبٍ يُحارب انقراضًا مزدوجًا: انقراض الوجود السياسي، وانقراض الذاكرة.
♣︎♣︎ الفصل الثالث: البنية الاجتماعية والسياسية – التماسك والانقسام في مجتمع الهامش.
تتشكَّل البنية الاجتماعية والسياسية الكردية من تناقضاتٍ جذرية: مجتمع قبليٌّ يتصارع مع مفاهيم الدولة الحديثة، حركاتٌ سياسيةٌ ثورية تتصادم مع المحافظة الدينية، ونخبٌ مثقفةٌ تحاول جسر الهوة بين الهوية التقليدية ومتطلبات الحداثة. هذا الفصل يدرس كيف تُنتج هذه التناقضات ديناميكيات فريدة، تُمكِّن الكرد من الصمود ككيانٍ اجتماعي، لكنها تعرقل أيضًا تحقيق الوحدة السياسية المنشودة.
١. النظام القبلي والعشائري: بين التماسك والانحلال
ظلَّت القبيلة (أو عشيرة) الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي الكردي حتى القرن العشرين، معتمدًا على:
الزعامات الهرمية:
دور الآغا (الزعيم القبلي) كوسيط بين الدولة والمجتمع، يجمع بين السلطتين القضائية والعسكرية.
الشيخ الصوفي كمرجعية دينية-سياسية، مثل شيخ الطريقة النقشبندية في جنوب كردستان.
الولاءات المتعددة: يتنازع الفرد الكردي بين الانتماء للقبيلة، للدين، وللهوية القومية، مما يُضعف مشاريع الدولة المركزية، كما يوضح الأنثروبولوجي مارتن فان برونسين.
لكن القرن الحادي والعشرين شهد تحولاتٍ جذرية:
الهجرة إلى المدن: أدى نزوح ملايين الكرد (خاصةً في تركيا) إلى مراكز حضرية مثل ديار بكر وإسطنبول، إلى تآكل السلطة القبلية، وبروز هويات جديدة قائمة على الطبقة الاجتماعية.
الصراع الأيديولوجي: استغلت الأحزاب السياسية (مثل حزب العمال الكردستاني PKK) انهيار النظام القبلي لتجنيد الشباب، معادينًة “الإقطاع القبلي” كجزء من خطابهم الثوري.
٢. الحركات السياسية: من القومية إلى الكونفدرالية
تنقسم الخريطة السياسية الكردية إلى تياراتٍ متصارعة، تعكس الانقسامات الجغرافية والأيديولوجية:
♧ التيار القومي التقليدي:
حزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) في العراق، بزعامة البارزانيين، الذي يؤمن بالدولة القومية عبر التفاوض مع القوى الدولية.
الحزب الوطني الكردستاني (PNK) في إيران، الذي يُركِّز على النضال المسلح منذ ثورة مهاباد.
♧ التيار الاشتراكي الثوري:
حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تخلَّى عن هدف الدولة القومية لصالح نموذج “الكونفدرالية الديمقراطية” الذي صاغه زعيمه عبد الله أوجلان، القائم على الإدارة الذاتية والبيئية، كما في تجربة روج آفا (شمال سوريا).
حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في سوريا، الذراع السياسية لقوات وحدات حماية الشعب (YPG).
♧ التيار الإسلامي:
حركات مثل حزب الحرية الكردستاني (PAK) في إيران، التي تدمج الخطاب القومي مع الإسلام السياسي، مستفيدةً من التديُّن الشعبي في الريف.
هذا التعدد يُنتج تحالفاتٍ هشة، كما في الصراع بين KDP وPUK (الاتحاد الوطني الكردستاني) في العراق على موارد النفط، أو التوتر بين PKK وتركيا حول استخدام الأراضي الحدودية.
٣. المرأة الكردية: بين خطاب التحرير والواقع المُعقَّد
أصبحت المرأة الكردية رمزًا عالميًّا للمقاومة، خاصةً بعد دور وحدات حماية المرأة (YPJ) في محاربة داعش. لكن هذا الخطاب التحرري يُخفي تعقيدات الواقع:
♧ التقدم النسبي:
حصص نسائية إلزامية (40%) في برلمان إقليم كردستان العراق.
قوانين تجريم تعدد الزوجات وتشديد عقوبات “جرائم الشرف” في إقليم كردستان.
♧ التحديات المستمرة:
ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء في باكور كردستان (تركيا) بسبب القمع العائلي، وفق تقارير منظمة حماية المرأة الكردية.
استغلال الأحزاب السياسية لصورة “المقاتلة الثورية” لتلميع صورتها دوليًّا، دون تمكين حقيقي،.
٤. الاقتصاد السياسي: النفط والزراعة كأدوات للسلطة
يُشكِّل الاقتصاد محورًا مركزيًّا في الصراع على كردستان:
♧ النفط في العراق:
تحكُّم حكومة إقليم كردستان في ٤٥ مليار برميل من الاحتياطيات، مما أتاح لها تعزيز الحكم الذاتي، لكنه أشعل نزاعاتٍ مع بغداد، كما في أزمة تصدير النفط عبر تركيا ٢٠١٤.
♧ الزراعة التقليدية:
تدمير النظام الإيكولوجي في جنوب شرق تركيا بسبب سدود مشروع GAP، الذي حوَّل مزارعي القطن الكرد إلى عمالٍ مهاجرين.
٥. التدخل الدولي: الكرد كأداةٍ جيوسياسية
تاريخيًّا، استُخدم الكرد كـ”ورقة تفاوض” من قبل القوى العظمى:
♧ الولايات المتحدة:
دعمت البشمرگة ضد صدام حسين (1991)، ثم YPG ضد داعش (2014)، لكنها تخلت عنهم لصالح تركيا في عمليتيّ عفرين (2018) وسلمانية (2019).
♧ روسيا:
توظِّف وجودها في سوريا للضغط على تركيا عبر دعم YPG بشكلٍ انتقائي.
♧ إيران:
تدعم أحزابًا كرديةً في العراق (كحزب كوملة) لزعزعة استقرار تركيا، بينما تقمع الكرد الإيرانيين.
♧♧ خاتمة الفصل: السلطة كسُلَّمٍ مكسور.
البنية الاجتماعية والسياسية الكردية تُشبه “الفيدرالية القسرية”: وحداتٌ متنافرةٌ تجمعها رغبةٌ في البقاء، لكنها تفتقر إلى الرؤية الموحدة. فشل المشروع الوطني الكردي ليس بسبب ضعف الخارج فحسب، بل أيضًا للتناقضات الداخلية التي تُنتجها القبيلة، الأيديولوجيا، والاقتصاد الريعي. ومع ذلك، فإن هذه الفوضى نفسها هي ما يجعل الكرد لاعبًا لا يُستهان به في لعبة الشرق الأوسط الدموية، حيث يُعيدون تعريف مفاهيم مثل “الدولة” و”المواطنة” من هوامش التاريخ.
في ♣︎♣︎ الفصل الرابع: كردستان ككيان جيوسياسي – الجغرافيا كسجنٍ وقوة.
تُجسِّد كردستان، ككيانٍ جغرافي-سياسي غير مُعترف به، مفارقةً وجودية: فَرَضَتْ عليها حدودُ دولٍ أربع (تركيا، إيران، العراق، سوريا) واقعًا مُجزَّأً، لكنها تحوَّلت، بفعل صراعات الشرق الأوسط، إلى لاعبٍ مركزيٍّ في المعادلات الإقليمية والدولية. هذا الفصل يدرس كيف تحوَّلت “فكرة كردستان” من فكرة قوميةٍ إلى واقعٍ جيوسياسيٍ مُعقد، عبر تحليل ثلاثية: الموارد (النفط، المياه، الزراعة)، الديموغرافيا (التوزيع، النزوح، الهجرة)، والاستراتيجيات الدولية (الكرد كأداةٍ وضحية).
١. التركيبة الديموغرافية: الأكثرية اللامرئية
رغم تقديرات عدد الكرد بـ ٣٠-٤٠ مليونًا، تظل ديموغرافيتهم مثار جدلٍ سياسي:
♧ تركيا: يُشكِّل الكرد ≈١٨% من السكان (١٥ مليونًا)، متمركزين في الجنوب الشرقي (ديار بكر، وان)، مع وجودٍ كبيرٍ في إسطنبول بسبب الهجرة القسرية.
♧ إيران: ≈١٠% (٨ ملايين)، في محافظات كردستان، كرمنشاه، وأذربيجان الغربية.
♧ العراق: ≈٢٠% (٦ ملايين)، مع حكم ذاتي دستوري منذ ٢٠٠٥.
♧ سوريا: ≈١٠% (٣ ملايين)، غالبيتهم في مناطق الحسكة والقامشلي.
هذه التوزيعات أنتجت هوياتٍ فرعية: كرد تركيا (باكور)، كرد إيران (روهلات)، كرد العراق (باشور)، كرد سوريا (روج آفا)، لكلٍّ منها خصوصيته السياسية والثقافية.
٢. الموارد الطبيعية: النفط بين السلاح واللعنة
إقليم كردستان العراق:
يمتلك ≈٤٥ مليار برميل نفط (٦% من الاحتياطي العالمي)، لكن النزاع مع بغداد على عائداته (اتفاقية ٢٠٠٥ المُلتبسة) حوَّله إلى سلاحٍ ذي حدين:
مكَّن الإقليم من بناء مؤسسات شبه دولة (جيش البشمرگة، برلمان، خدمات صحية).
أشعل حربًا اقتصادية مع بغداد، كما في أزمة تصدير النفط عبر تركيا ٢٠١٤، التي أوقفت الإقليم عن صرف الرواتب لـ٦ أشهر.
♧ المياه كسلاح جيوسياسي:
مشروع GAP التركي (٢٢ سدًّا على دجلة والفرات) خفَّض تدفق المياه إلى سوريا والعراق بنسبة ٥٠%، مُدمرًا الزراعة الكردية التقليدية (التبغ، الرمان). ★ اعتقد ان هذه السدود سبب رئيسي للزلازل فى تركيا★
في المقابل، تستخدم سوريا نهر الخابور (في الحسكة) للضغط على إدارة شمال شرق سوريا الكردية.
٣. الصراعات الحدودية: كردستان كساحة حرب بالوكالة.
♧ تركيا وسوريا:
اجتياح عفرين ٢٠١٨، وعمليتا “نبع السلام” (٢٠١٩) و”مخلب النسر” (٢٠٢٠) ضد وحدات YPG، بدعمٍ من فصائل سورية معارضة.
بناء “المنطقة الآمنة” على الحدود، التي هُجِّر منها ٣٠٠ ألف كردي، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
♧ إيران والعراق:
قصف إيراني متكرر لمعسكرات أحزاب كردية معارضة (حزبي كوملة وديموكرات) في إقليم كردستان العراق، بدعوى دعمها “الانفصاليين الإيرانيين”.
♧ العراق والكويت:
نزاع على ميناء ميناء الفاو الكبير، الذي يطمح إقليم كردستان لاستخدامه كمنفذٍ بحريٍ بديلٍ عن تركيا.
٤. النزوح واللجوء: الكرد كشعبٍ مُهجَّر
♧ الكرد الفيليون:
طُردوا من العراق إبان حكم صدام حسين (١٩٨٠) بتهمة “التجسس لصالح إيران”، وعادوا بعد ٢٠٠٣ ليجدوا أملاكهم مُصادَرة.
♧ لاجئو روج آفا:
نزوح ٣٠٠ ألف كردي سوري إلى العراق بعد الغزو التركي ٢٠١٩، حسب مفوضية اللاجئين.
♧ الكرد في أوروبا:
يُشكِّلون أكبر جاليةٍ كرديةٍ في الشتات (≈١.٥ مليون في ألمانيا)، يُؤثرون في السياسة الأوروبية عبر جماعات الضغط (مثل المجلس الكردي في بروكسل).
٥. الاستراتيجيات الدولية: الكرد بين الاستخدام والتخلي.
♧ الولايات المتحدة:
دعمت الكرد كحلفاء تكتيكيين (البشمرگة ضد صدام، YPG ضد داعش)، لكنها تخلت عنهم مرارًا (كالسماح باجتياح عفرين ٢٠١٨).
وفقًا لوثائق ويكيليكس، وصف الدبلوماسي الأمريكي پول بريمر الكرد بأنهم “أفضل أصدقائنا المؤقتين”.
♧ روسيا:
تستخدم وجودها في سوريا للضغط على تركيا عبر دعم YPG، لكنها سمحت لأنقرة بقصف مناطق كردية في إدلب ٢٠٢٠.
٦. مستقبل كردستان: بين الكونفدرالية والتفكك
نموذج الكونفدرالية الديمقراطية:
الذي تبناه أوجلان، يقترح كياناتٍ ذاتية الحكم مرتبطة اتحاديًّا، لكنه يصطدم برفض الدول الحاكمة واختلاف الرؤى الكردية.
♧ سيناريو التقسيم:
يحذر الباحث گاريث ستانزفيلد من أن التنافس بين الكيانات الكردية (إقليم كردستان العراق vs. إدارة شمال سوريا) قد يؤدي إلى تفكيك “الفكرة الكردستانية” لصالح كياناتٍ مصغَّرة.
♧ الدولة القومية المستحيلة:
حتى لو تحققت، ستواجه تحدياتٍ وجودية: اقتصادات هشة، حدودٌ معادية، وغياب الوحدة الداخلية.
♧♧ خاتمة الفصل: الجغرافيا كقدرٍ ومصير.
كردستان، ككيانٍ جيوسياسي، ليست مجرد “أرضٍ بلا شعب”، بل شعبٌ يعيش فوق أرضٍ متنازعٍ عليها. إنها حالةٌ فريدةٌ من “اللادولة” التي تُعيد تعريف مفاهيم السيادة في القرن الحادي والعشرين. رغم ذلك، فإن قوتها تكمن في ضعفها: فغياب الدولة جعل الكرد أسيادًا في فنِّ البقاء، حيث يحوِّلون كل أزمةٍ إلى فرصةٍ للتفاوض، وكل هزيمةٍ إلى ملحمةٍ تُضاف إلى ذاكرتهم الجماعية. كما كتب المؤرخ ديڤيد ماكدوال:
“الكرد شعبٌ لم يمتلك دولته قط، لكنه يمتلك تاريخًا يفرض على العالم الاعتراف به”.
هذا الفصل يؤكد أن كردستان، رغم تشظيها، هي اختبارٌ مصيريٌ لفكرة “الشرق الأوسط الجديد”: هل سيكون فسيفساءً من الهويات، أم ساحةً لصراع الهويات حتى الإبادة؟
♣︎♣︎ الخاتمة والنقد التحليلي: الكرد بين أسطورة الصمود وواقع التشرذم
بعد هذا المسار البحثي الشامل، يبرز سؤال مركزي: هل يمكن للكرد، بعد قرون من التمزق الجيوسياسي والثقافي، أن يحوّلوا “فشلهم” في إقامة دولة قومية إلى نموذج بديل للوجود السياسي في الشرق الأوسط؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب تفكيك المفارقات الأساسية التي كشفتها الدراسة:
التناقض التاريخي: الوحدة الثقافية مقابل التشرذم السياسي.
رغم نجاح الكرد في الحفاظ على هوية ثقافية متماسكة عبر اللغة، الدين، والفنون، فإن افتقارهم إلى مشروع سياسي موحد يظل أبرز إخفاقاتهم. فـ”كردستان” ليست كيانًا جغرافيًّا فحسب، بل فكرةٌ تتعارض معها الانقسامات الداخلية: تنافس الأحزاب (KDP vs. PKK)، وتضارب المصالح بين إقليم كردستان العراق الغني بالنفط وإدارة شمال سوريا الفقيرة. هذه الانقسامات، كما يوضح الباحث گاريث ستانزفيلد، ليست نتاجًا للتدخلات الخارجية فقط، بل تعكس صراعًا بين النخب الكردية نفسها على شرعية تمثيل “الكردوتوبيا” (المدينة الفاضلة الكردية).
الهوية المركبة: بين التمرد والتكيف.
تكشف الثقافة الكردية عن قدرة فريدة على استيعاب التناقضات: فالشعب الذي قاتل لقرون تحت راية الإسلام (الأيوبيون) هو نفسه الذي أنتج حركاتٍ علمانيةً متطرفةً (PKK). هذه “الهُجنة الهوياتية” تُشكّل مصدر قوةٍ وضعفٍ في آنٍ: فهي تسمح بالمرونة في مواجهة القمع، لكنها تهدد بفقدان الجوهر الثقافي، كما يظهر في صراع الأجيال بين كرد الريف (المتمسكين بالتقاليد) وكرد المدن (المتأثرين بالعولمة).
الجيوسياسيا كسجنٍ مفتوحٍ.
أصبحت كردستان، رغم انعدام سيادتها، لاعبًا جيوسياسيًّا لا يُستهان به. فالقوى الدولية تستخدمها كـ”ورقة ضغط” متى شاءت (دعم أمريكا لـYPG ضد داعش)، ثم تتخلى عنها لصالح مصالح أكبر (مثل صفقة تركيا لشراء S-400 الروسية التي ضحّت بها واشنطن بالكرد). هذا الواقع يعيد إنتاج حلقة مفرغة: الكرد كضحايا للتاريخ حين يُهزمون، وكأبطالٍ له حين ينتصرون، لكنهم نادرًا ما يكونون صنّاع مصيرهم.
النقد الذاتي: إشكالية الرواية الواحدة.
لا تخلو السرديات الكردية من مبالغاتٍ تخدم الأجندة السياسية:
الرواية القومية: تتعامل مع التاريخ كسلسلة انتصاراتٍ مبطنةٍ (مثل تمجيد ثورة مهاباد رغم فشلها الذريع).
الرواية الثورية: تختزل الكرد في صورة “المقاوم الاشتراكي” (كما في خطاب PKK)، متجاهلةً التنوع الديني والطبقي.
مستقبل الكرد: بين الكونفدرالية والنسيان.
رغم التحديات، تبرز فرصٌ غير مسبوقة:
التجربة السورية: نموذج الإدارة الذاتية في روج آفا، رغم هشاشته، يقدم بديلًا عن الدولة القومية عبر مفاهيم مثل اللامركزية والتمثيل النسوي.
القوة الناعمة: انتشار الثقافة الكردية عبر الفنون (موسيقى شڤان پرور، أفلام نوري بيلجى سيلان) يخلق تعاطفًا عالميًّا.
الشتات الكردي: جاليات المهجر تُشكل لوبيات ضغطٍ (كالمجلس الكردي في بروكسل) قد تُعيد تعريف الدبلوماسية الكردية.
★★★ خلاصة نقدية: التاريخ لا يُكتب بالأمنيات.
الكرد، كشعبٍ بلا دولة، هم اختبارٌ حيٌ لفشل نظام ويستفاليا في الشرق الأوسط. إنهم يعيشون في “اللامكان” الجغرافي، لكنهم يسكنون “كل مكان” في الخيال السياسي. رغم ذلك، فإن تحويل مأساتهم إلى ملحمةٍ لن يكفي: فالشعارات الرومانسية (“الشعب الذي لا يموت”) يجب أن توازيها مراجعةٌ نقديةٌ للذات، وخطةٌ استراتيجيةٌ تستفيد من تناقضات الإقليم (كاستغلال التنافس التركي-الإيراني).
كما كتب المفكر الكردي الثائر عبد الله أوجلان من سجنه:
“الدولة ليست الحل، بل المشكلة”.
ربما يكون مصير الكرد هو تقديم إجابةٍ عن سؤالٍ أكبر: كيف نعيش كشعوبٍ بلا حدودٍ في عالمٍ يُقدس الحدود.
المقال منشور في جريدة يكيتي العدد “331”